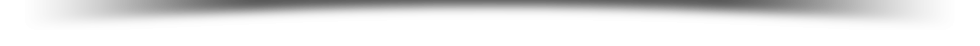كتبه
أبو مريم أيمن بن دياب العابديني
غفر الله تعالى له ولوالديه
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد،،،
فيا أيها القارئ الكريم اعلم أن الله تعالى شرع للمسلمين إذا صلَّوْا جَماعة أن يصفُّوا صفوفاً مُنتظمة ولعل من حُكمها وَمَقاصدها أنْ تُذَكِّر المسلمين بما يَنبغي أنْ يكونوا عليهِ من الألفةِ والاجتماعِ والاتفاقِ على الحقِ والخيرِ حتى يكونوا كالجسدِ الواحدِ.
وشَرع لهذه الصفوفُ فضائلاً وأحكاماً كثيرة نحن في أمس الحاجة إلى العلم بها والفقه فيها لأننا مأمورون أن نصلي جماعة خمس مرات في كل يوم وليلة ولأنه لا تَتمُّ إقامةُ الصَّلاة إلاَّ بإقامة الصُّفوف؛ لذلك جاءت الأحاديث تترى في تقرير هذا, تارةً بالتَّرغيب في إقامة الصُّفوف وإحسانها, وتارةً بالتَّرهيب من التَّفريط فيها, فمن ذلكم:
(1) تَعْرِيفُ الصَّفِّ فِي اللُّغَةِ : السَّطْرُ الْمُسْتَقِيمُ مِنْ كُل شَيْءٍ، وَالْقَوْمُ الْمُصْطَفُّونَ وَجَعْل الشَّيْءِ - كَالنَّاسِ وَالأَْشْجَارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ - عَلَى خَطٍّ مُسْتَوٍ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى:{ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ }[الصف / 4]، وَصَافَّ الْجَيْشُ عَدُوَّهُ : قَاتَلَهُ صُفُوفًا، وَتَصَافَّ الْقَوْمُ : وَقَفُوا صُفُوفًا مُتَقَابِلَةً. أنظر: لسان العرب ، المصباح المنير ، مادة ( صف ).
قلت: وَلاَ يَخْرُجُ مَعْنَاهُ الاِصْطِلاَحِيُّ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ .
قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله-: ((وَالْمُرَاد بِتَسْوِيَة الصُّفُوف اِعْتِدَال الْقَائِمِينَ بِهَا عَلَى سَمْتٍ وَاحِدٍ، أَوْ يُرَادُ بِهَا سَدّ الْخَلَلِ الَّذِي فِي اَلصَّفِّ )) (أنظر:"فتح الباري"(2/207).
(2) حُكْمُ تَسْوِيَةُ الصَّفِّ: اخْتُلفَ فيه على قولين:
الأول: ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَسْوِيَةُ الصُّفُوفِ فِي صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ بِحَيْثُ لاَ يَتَقَدَّمُ بَعْضُ الْمُصَلِّينَ عَلَى الْبَعْضِ الآْخَرِ، وَيَعْتَدِل الْقَائِمُونَ فِي الصَّفِّ عَلَى سَمْتٍ وَاحِدٍ مَعَ التَّرَاصِّ .
الثاني : وهو الراجح للأدلة ذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ - مِنْهُمُ الأئمة البخاري، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن حزم، وابن خُزيمة، والحافظ المنذري، والحافظ ابن حجر، والشوكانى ، والصنعاني، وابن باز، والألباني، وابن عثيمين –رحمهم الله- إِلَى وُجُوبِ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ لِقَوْلِهِ e : " لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ " (متفق عليه)، فَإِنَّ وُرُودَ هَذَا الْوَعِيدِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ التَّسْوِيَةِ، وَالتَّفْرِيطُ فِيهَا حَرَامٌ؛ وَلأَِمْرِهِ e بِذَلِكَ وَأَمْرُهُ لِلْوُجُوبِ مَا لَمْ يَصْرِفْهُ صَارِفٌ، وَلاَ صَارِفَ هُنَا .
قَال الحافظ ابْنُ حَجَرٍ-رحمه الله-: تحت حديث أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ t لما قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَقِيلَ لَهُ مَا أَنْكَرْتَ مِنَّا مُنْذُ يَوْمِ عَهِدْتَ رَسُولَ اللَّهِ e قَالَ: « مَا أَنْكَرْتُ شَيْئًا إِلاَّ أَنَّكُمْ لاَ تُقِيمُونَ الصُّفُوفَ ». رواه البخاري ح (724)، وَمَعَ الْقَوْل بِأَنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ وَاجِبَةٌ فَصَلاَةُ مَنْ خَالَفَ وَلَمْ يُسَوِّ صَحِيحَةٌ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ: أَنَّ أَنَسًا مَعَ إِنْكَارِهِ عَلَيْهِمْ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِإِعَادَةِ الصَّلاَةِ . (أنظر: فتح الباري 2 / 206).
(3) تَرْتِِيِبُ الصُّفُوُف: عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ t قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ e يَقُولُ:« لِيَلِنِى مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ » رواه مسلم ح(432)، وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ t قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ e:« لِيَلِنِى مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ - ثَلاَثًا - وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاقِ » رواه مسلم ح(123)، ففي هذا الحديث ترتيب الصفوف على حسب الأفضلية خلف الإمام: الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء، ما لم يسبق الصبيان إلى الصفوف الأُول، أو يمنع مانع، فإن سبقوا فهم أولى بها، أما إذا كان المأموم واحد، فإنه يقف على يمين الإمام، لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ t قَالَ: « قَامَ النَّبِىُّ e يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ أُصَلِّى مَعَهُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِرَأْسِى فَأَقَامَنِى عَنْ يَمِينِهِ » متفق عليه، وإذا كان المأمومون اثنان وقفا خلفه، لحديث جابر بن عبد الله t وفيه:« جِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ e فَأَخَذَ بِيَدِى فَأَدَارَنِى حَتَّى أَقَامَنِى عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ e فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ e بِيَدَيْنَا جَمِيعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ» رواه مسلم ح(766)، وإذا كانت امرأة واحدة وقفت خلف الرجال، لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ tوفيه: « فَأَقَامَنِى عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا » متفق عليه، وإذا كان المأمومون: امرأتان ورجل وقف الرجل على يمين الإمام والمرأتان خلف الإمام لرواية أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ tوفيها: « ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ تَطَوُّعًا فَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ حَرَامٍ خَلْفَنَا. قَالَ: "أَقَامَنِى عَنْ يَمِينِهِ عَلَى بِسَاطٍ" » صحيح سنن أبي داود ح(608).
(4) تَسْوِيةُ الصُّفُوُف: عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ t قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ e:« لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ » متفق عليه، وفي لفظ لمسلم: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ e يُسَوِّى صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّى بِهَا الْقِدَاحَ حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ فَرَأَى رَجُلاً بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ فَقَالَ:« عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ »متفق عليه، وظاهر هذه الأحاديث وجوب تسوية الصفوف كما بَيَّنَّا آنفاً.
ألفاظ النبي e في تسوية الصفوف أنواع : وعلى الإمام الإتيان بها وعدم الزيادة عليها بألفاظ من عنده مخترعة وخير الهدى هدي محمد e.
النوع الأول: « أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا » رواه البخاري ح (719) عَنْ أَنَسٍ t.
النوع الثاني: « سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ » متفق عليه عَنْ أَنَسٍ t.
النوع الثالث: « سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَة الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ » رواه مسلم ح (433) عَنْ أَنَسٍ t. قال العلاَّمة ابن عثيمين-رحمه الله-:(المقصود بالتمام هنا تمام الكمال على القول الراجح) [كتب ورسائل للعثيمين 181/ 10].
النوع الرابع: « أَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلاَة » رواه مسلم ح (435) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي-رحمه الله-: (والمراد : أن الصف إذا أقيم في الصلاة كانَ ذَلِكَ من حسنها، فإذا لم يقم نقص من حسنها بحسب ما نقص من إقامة الصف) [فتح الباري لابن رجب 4/ 259].
النوع الخامس: « اسْتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ » رواه مسلم ح (432) عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ t.
النوع السادس: « أَتِمُّوا الصُّفُوفَ » رواه مسلم ح (434) عَنْ أَنَسٍ t بلفظ:« أَتِمُّوا الصُّفُوفَ فَإِنِّى أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِى ».
النوع السابع: « أَقِيمُوا الصُّفُوفَ» رواه البخاري ح (725) عَنْ أَنَسٍ t بلفظ:« أَقِيمُوا الصُّفُوفَ فَإِنِّى أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِى ».
النوع الثامن: « أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ـ ثَلاَثًا » صحيح سنن أبي داود ح(622) عَنْ النُّعْمَانِ بْنُ بَشِيرٍ t بلفظ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ e بِوَجْهِهِ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ « أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ - ثَلاَثاً - وَاللَّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ». قَالَ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَتِهِ وَمَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِهِ.
النوع التاسع: « أَقِيمُوا الصُّفُوفَ، وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ، وَلِينُوا بِأَيْدِى إِخْوَانِكُمْ، وَلاَ تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ » صحيح سنن أبي داود ح(666) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ t ، قَالَ الإمام أَبُو دَاوُدَ-رحمه الله- وَمَعْنَى:« وَلِينُوا بِأَيْدِى إِخْوَانِكُمْ ». إِذَا جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الصَّفِّ فَذَهَبَ يَدْخُلُ فِيهِ فَيَنْبَغِى أَنْ يُلَيِّنَ لَهُ كُلُّ رَجُلٍ مَنْكِبَيْهِ حَتَّى يَدْخُلَ فِى الصَّفِّ.
النوع العاشر: « رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالأَعْنَاقِ» صحيح سنن أبي داود ح(667) عَنْ أَنَسٍ t:« فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنِّى لأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ ».
النوع الحادي عشر: « أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ، ثُمَّ الَّذِى يَلِيهِ، فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِى الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ » صحيح سنن أبي داود ح(671) عَنْ أَنَسٍ t.
النوع الثاني عشر: « اسْتَوُوا، اسْتَوُوا، اسْتَوُوا » صحيح النسائي ح(813) عَنْ أَنَسٍ t.
النوع الثالث عشر: « لاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ » صحيح سنن أبي داود ح(664) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍt.
النوع الرابع عشر: « أَحْسِنُوا إِقَامَةَ الصُّفُوفِ فِى الصَّلاَةِ » صحيح الجامع ح (159) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t.
النوع الخامس عشر: « أَلاَ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ ». فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ قَالَ: « يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الأُوَلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِى الصَّفِّ » رواه مسلم ح (430) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ t.
النوع السادس عشر: « إِنَّ مِن تَمَامِ الصَّلاَة إِقَامَةُ الصَّفِّ » صحيح الجامع ح (2225) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللهِ t . قال الإمام زين الدين العراقي -رحمه الله-: ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَى إقَامَةِ الصَّفِّ أُمُورًا :
(أَحَدُهَا) حُصُولُ الِاسْتِقَامَةِ وَالِاعْتِدَالِ ظَاهِرٌ كَمَا هُوَ الْمَطْلُوبُ بَاطِنًا .
(ثَانِيهَا) لِئَلَّا يَتَخَلَّلَهُمْ الشَّيْطَانُ فَيُفْسِدَ صَلَاتَهُمْ بِالْوَسْوَسَةِ.
(ثَالِثُهَا) مَا فِي ذَلِكَ مِنْ حُسْنِ الْهَيْئَةِ .
(رَابِعُهَا) أَنَّ فِي ذَلِكَ تَمَكُّنَهُمْ مِنْ صَلَاتِهِمْ مَعَ كَثْرَةِ جَمْعِهِمْ فَإِذَا تَرَاصُّوا وَسِعَ جَمِيعَهُمْ الْمَسْجِدُ وَإِذَا لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ ضَاقَ عَنْهُمْ .
(خَامِسُهَا) أَنْ لَا يَشْغَلَ بَعْضُهُمَا بَعْضًا بِالنَّظَرِ إلَى مَا يَشْغَلُهُ مِنْهُ إذَا كَانُوا مُخْتَلِفِينَ وَإِذَا اصْطَفُّوا غَابَتْ وُجُوهُ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ وَكَثِيرٌ مِنْ حَرَكَاتِهِمْ وَإِنَّمَا يَلِي بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ظُهُورَهُمْ. أنظر:طرح التثريب (2/530).
قُلْتُ: وَمِنْ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ إِكْمَال الصَّفِّ الأَْوَّل فَالأَْوَّل، وَأَنْ لاَ يُشْرَعَ فِي إِنْشَاءِ الصَّفِّ الثَّانِي إِلاَّ بَعْدَ كَمَال الأَْوَّل، وَهَكَذَا. وَهَذَا مَوْضِعُ اتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ لِقَوْلِهِ e:" أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيَهُ، فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ" صحيح الجامع (122)، كَمَا يُسْتَحَبُّ سَدُّ الْفُرَجِ، وَالإِْفْسَاحُ لِمَنْ يُرِيدُ الدُّخُول فِي الصَّفِّ لِقَوْلِهِ e:" أَقِيمُوا الصُّفُوفَ، وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَل، وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، وَلاَ تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، وَمَنْ وَصَل صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ " صحيح الجامع (1187)، وَعَلَيْهِ فَلاَ يَقِفُ فِي صَفٍّ وَأَمَامَهُ صَفٌّ آخَرُ نَاقِصٌ أَوْ فِيهِ فُرْجَةٌ، بَل يَشُقُّ الصُّفُوفَ لِسَدِّ الْخَلَل أَوِ الْفُرْجَةِ الْمَوْجُودَةِ فِي الصُّفُوفِ الَّتِي أَمَامَهُ، وَيُسْتَحَبُّ الاِعْتِدَال فِي الصُّفُوفِ، فَإِذَا وَقَفُوا فِي الصَّفِّ لاَ يَتَقَدَّمُ بَعْضُهُمْ بِصَدْرِهِ أَوْ غَيْرِهِ وَلاَ يَتَأَخَّرُ عَنِ الْبَاقِينَ، وَيُسَوِّي الإِْمَامُ بَيْنَهُمْ فَفِي صَحِيحِ ابْنِ خُزَيْمَةَ عَنِ الْبَرَاءِ t كَانَ النَّبِيُّ e يَأْتِي نَاحِيَةَ الصَّفِّ وَيُسَوِّي بَيْنَ صُدُورِ الْقَوْمِ وَمَنَاكِبِهِمْ، وَيَقُول:" لاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الأُْوَل"صحيح الترغيب والترهيب ح(513)؛ ولِلأَْحَادِيثِ السَّابِقَةِ.أنظر:[الموسوعة الفقهية 27/ 36]بتصرف.
قَال الإمام النَّوَوِيُّ-رحمه الله-: وَاسْتِحْبَابُ الصَّفِّ الأَْوَّل ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ إِلَى آخِرِهَا - هَذَا الْحُكْمُ مُسْتَمِرٌّ فِي صُفُوفِ الرِّجَال بِكُل حَالٍ، وَكَذَا فِي صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُنْفَرِدَاتِ بِجَمَاعَتِهِنَّ عَنْ جَمَاعَةِ الرِّجَال، أَمَّا إِذَا صَلَّتِ النِّسَاءُ مَعَ الرِّجَال جَمَاعَةً وَاحِدَةً، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ فَأَفْضَل صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا. (المجموع 4 / 301) .
وقال العلاَّمة ابن عثيمين-رحمه الله-: (( وتسوية الصَّفِّ تكون بالتساوي، بحيث لا يتقدَّم أحدٌ على أحد.
ثم إن تسوية الصَّفِّ المتوعَّد على مخالفتها في قوله e:« لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ »متفق عليه، هي تسويته بالمحاذاة، ولا فَرْقَ بين أن يكون الصَّفُّ خلف الإِمام أو مع الإِمام، وعلى هذا؛ فإذا وقف إمامٌ ومأموم فإنه يكون محاذياً للمأموم، ولا يتقدَّم عليه خلافاً لمن قال من أهل العلم: إنه ينبغي تقدُّم الإِمام على المأموم يسيراً؛ ليتميَّز الإِمامُ عن المأموم.
وهناك تسوية أخرى بمعنى الكمال؛ يعني: الاستواء بمعنى الكمال كما قال الله تعالى:{وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى}[القصص: 14]، أي: كَمُلَ، فإذا قلنا: استواءُ الصَّفِّ بمعنى كماله؛ لم يكن ذلك مقتصراً على تسوية المحاذاة، بل يشمَل عِدَّة أشياء:
(1) تسويةَ المحاذاة، وهذه على القول الرَّاجح واجبة، وقد سبقت.
(2) التَّراصَّ في الصَّفِّ، فإنَّ هذا مِن كماله، وكان النبيُّ e يأمر بذلك، ونَدَبَ أمَّتَهُ أن يصفُّوا كما تصفُّ الملائكةُ عند ربِّها، يتراصُّون ويكملون الأول فالأول، ولكن المراد بالتَّراصِّ أن لا يَدَعُوا فُرَجاً للشياطين، وليس المراد بالتَّراص التَّزاحم؛ لأن هناك فَرْقاً بين التَّراصِّ والتَّزاحم؛ ولهذا كان النبيُّ e يقول:" أَقِيمُوا الصُّفُوفَ، وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ ...وَلاَ تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ..." صحيح الجامع (1187) أي: لا يكون بينكم فُرَج تدخل منها الشياطين؛ لأن الشياطِين يدخلون بين الصُّفوفِ كأولاد الضأن الصِّغارِ (صحيح الترغيب والترهيب ح (491)) ؛ من أجل أن يُشوِّشوا على المصلين صلاتَهم.
(3) إكمالَ الأول فالأول، فإنَّ هذا مِن استواءِ الصُّفوف، فلا يُشرع في الصَّفِّ الثاني حتى يَكمُلَ الصَّفُّ الأول، ولا يُشرع في الثالث حتى يَكمُلَ الثاني وهكذا . ومِنْ لَعِبِ الشيطان بكثير من الناس اليوم: أنهم يرون الصفَّ الأول ليس فيه إلا نصفُه، ومع ذلك يشرعون في الصفِّ الثاني، ثم إذا أُقيمت الصلاة، وقيل لهم: أتمُّوا الصفَّ الأول، جعلوا يتلفَّتون مندهشين، وكل ذلك في الحقيقة سببه:
أولاً: الجهل العظيم.
وثانياً: أن بعضَ الأئمة لا يبالون بهذا الشيء ، أي: بتسوية المأمومين، وتراصِّهم وتكميلِ الأول فالأول. وهاهنا حديث مشهور بين النَّاسِ، وليس له أصلٌ وجب التنبه عليه وهو:« إنَّ اللَّهَ لا ينظرُ إلى الصَّفِّ الأعوج ».
(4) ومِن تسوية الصُّفوف: التقاربُ فيما بينها، وفيما بينها وبين الإِمام؛ لأنهم جماعةٌ، والجماعةُ مأخوذةٌ مِن الاجتماع : ولا اجتماع كامل مع التباعد، فكلما قَرُبَت الصُّفوفُ بعضها إلى بعض، وقَرُبَت إلى الإِمام كان أفضل وأجمل، ونحن نرى في بعض المساجد أنَّ بين الإِمام وبين الصَّفِّ الأول ما يتَّسع لصفٍّ أو صفَّين، أي: أنَّ الإِمام يتقدَّم كثيراً، وهذا فيما أظنُّ صادر عن الجهل، فالسُّنَّةُ للإمام أن يكون قريباً مِن المأمومين، وللمأمومين أن يكونوا قريبين مِن الإِمام، وأن يكون كلُّ صفٍّ قريباً مِن الصَّفِّ الآخر.
وحَدُّ القُرب: أن يكون بينهما مقدار ما يَسَعُ للسُّجودِ وزيادة يسيرة.
(5) ومِن تسوية الصُّفوفِ وكمالها: أن يدنوَ الإِنسانُ مِن الإِمامِ؛ لقول النبيِّ e:« لِيَلِنِى مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى»رواه مسلم ح (432)، وكلَّما كان أقربَ كان أَولى، ولهذا جاء الحثُّ على الدُّنوِّ مِن الإِمام في صلاة الجُمعة لأن الدُّنوَّ مِن الإِمام في صلاة الجُمعة يحصُل به الدُّنُو إليه في الصَّلاةِ، وفي الخطبة، فالدُّنُو مِن الإِمام أمرٌ مطلوب، وبعضُ الناس يتهاون بهذا؛ ولا يحرِصُ عليه.
(6) ومِن تسوية الصُّفوف: تفضيل يمين الصفِّ على شماله، يعني: أنَّ أيمن الصَّفِّ أفضل مِن أيسره، ولكن ليس على سبيل الإِطلاق؛ كما في الصَّفِّ الأول؛ لأنَّ اليمين أفضلُ مع التقارب؛ أما مع التَّباعد فلا شكَّ أنَّ اليسار القريب أفضل من اليمين البعيد.
(7) ومِن تسوية الصُّفوفِ: أن تُفرد النِّساءُ وحدَهن؛ بمعنى: أن يكون النِّساءُ خلف الرِّجال، لا يختلط النِّساء بالرِّجال إذاً؛ الأفضلُ أن تُؤخَّر النِّساءُ عن صفوفِ الرِّجَالِ لما في قُربهنَّ إلى الرِّجَال مِن الفتنة. وأشدُّ مِن ذلك اختلاطُهنَّ بالرِّجال، بأن تكون المرأةُ إلى جانب الرَّجُلِ، أو يكون صَفٌّ مِن النِّساءِ بين صُفوفِ الرِّجَال، وهذا لا ينبغي، وهو إلى التَّحريمِ مع خوف الفتنة أقربُ)) أنظر: الشرح الممتع (3/10ـ15) بتصرف.
(5) فَضْل الصَّفّ الأَوَّل:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ e:« لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاء وَالصَّفِّ الأَوَّل، لاَسْتَهَمُوا عَلَيهِ » متفق عليه.
وَعَنْهُ t عَنِ النَّبِيِّ e قَالَ :« لَوْ تَعْلَمُونَ أَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ، مَا كَانَتْ إِلاَّ قُرْعَة » رواه مسلم ح (439).
وَعَنْهُ t قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ e:« لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الأَوَّل لَكَانَتْ قُرْعَة » صحيح ابن ماجه ح (998).
قَالَ الإمام النَّوَوِيّ-رحمه الله-: وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفّ الْأَوَّل مِنْ الْفَضِيلَة، وَجَاءُوا إِلَيْهِ دَفْعَة وَاحِدَة وَضَاقَ عَنْهُمْ ، ثُمَّ لَمْ يَسْمَح بَعْضهمْ لِبَعْضٍ بِهِ، لَاقْتَرَعُوا عَلَيْهِ. وَفِيهِ إِثْبَات الْقُرْعَة فِي الْحُقُوق الَّتِي يَزْدَحِم عَلَيْهَا وَيُتَنَازَع فِيهَا. شرح مسلم (2/180).
عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ t قَالَ: قَالَ e:« إِنَّ الصَّفَّ الأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلاَئِكَةِ وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيلَتُهُ لاَبْتَدَرْتُمُوهُ » صحيح سنن أبي داود ح (554). أي في القرب من الله U، ونزول الرحمة، وإتمامه واعتداله، ويستفاد منه أن الملائكة يصفون لعبادة الله تعالى. (الفتح الرباني 5/171).
عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ t قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ e يَقُولُ :« إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الأَوَّلِ » صحيح ابن ماجه ح (997).
عَنِ الْعَرْبَاضِ بْنِ سَارِيَة t عَنْ رَسُوْلِ اللهِ e:« أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الصَّفِّ الأَوَّل ثَلاَثاً، وَعَلَى الَّذِي يَلِيه وَاحِدَة » صحيح النسائي ح (817).
وَعَنْهُ t أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ e:« كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلاَثاً، وَلِلثَّانِي مَرَّةً » صحيح ابن ماجه ح (996).
قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله-: قَوْلُهُ: « الصَّفِّ الأَوَّلِ » وَالْمُرَاد بِهِ مَا يَلِي الْإِمَامَ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: أَوَّلُ صَفٍّ تَامٍّ يَلِي الْإِمَامَ، لَا مَا تَخَلَّلَهُ شَيْءٌ كَمَقْصُورَة، وَقِيلَ: الْمُرَاد بِهِ مَنْ سَبَقَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَوْ صَلَّى آخِر اَلصُّفُوفِ، قَالَهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ-رحمه الله- وَاحْتَجَّ بِالِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّ مَنْ جَاءَ أَوَّل الْوَقْتِ وَلَمْ يَدْخُلْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَهُوَ أَفْضَلُ مِمَّنْ جَاءَ فِي آخِرِهِ وَزَاحَمَ إِلَيْهِ، وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِي ذَلِكَ كَمَا لَا يَخْفَى.
قَالَ الإمام النَّوَوِيّ-رحمه الله-: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ وَبِهِ صَرَّحَ الْمُحَقِّقُونَ، وَالْقَوْلَانِ الْآخَرَانِ غَلَط صَرِيح. اِنْتَهَى .
قَالَ الْعُلَمَاءُ : فِي الْحَضِّ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ الْمُسَارَعَة إِلَى خَلَاص اَلذِّمَّة، وَالسَّبْقُ لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ، وَالْفِرَارُ مِنْ مُشَابَهَةِ الْمُنَافِقِينَ، وَالْقُرْب مِنْ الْإِمَامِ، وَاسْتِمَاع قِرَاءَته وَالتَّعَلُّم مِنْهُ، وَالْفَتْح عَلَيْهِ، وَالتَّبْلِيغ عَنْهُ وَمُشَاهَدَةُ أَحْوَالِهِ، وَالسَّلَامَة مِنْ اِخْتِرَاقِ الْمَارَّةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَسَلَامَة الْبَال مِنْ رُؤْيَةِ مَنْ يَكُونُ قُدَّامَهُ، وَسَلَامَة مَوْضِعِ سُجُودِهِ مِنْ أَذْيَالِ الْمُصَلِّينَ؛ وَالتَّعَرُّضُ لِصَلاَةِ اللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ، وَدُعَاءُ نَبِيِّهِ e وَغَيْرُ ذَلِكَ. انظر:"فتح الباري" (2/244) بتصرف ، و[الموسوعة الفقهية الكويتية 27/ 38].
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ e:«خَيرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» رواه مسلم ح (440)، اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ أَفْضَل صُفُوفِ الرِّجَال - سَوَاءٌ كَانُوا يُصَلُّونَ وَحْدَهُمْ أَوْ مَعَ غَيْرِهِمْ مِنَ الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ - هُوَ الصَّفُّ الأَْوَّل، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ، ثُمَّ الأَْقْرَبُ فَالأَْقْرَبُ، وَكَذَا أَفْضَل صُفُوفِ النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رِجَالٌ . أَمَّا النِّسَاءُ مَعَ الرِّجَال فَأَفْضَل صُفُوفِهِنَّ آخِرُهَا؛ لأَِنَّ ذَلِكَ أَلْيَقُ وَأَسْتَرُ.
قَالَ الإمام النَّوَوِيّ-رحمه الله-: أَمَّا صُفُوف الرِّجَال فَهِيَ عَلَى عُمُومهَا فَخَيْرهَا أَوَّلهَا أَبَدًا وَشَرّهَا آخِرهَا أَبَدًا، أَمَّا صُفُوف النِّسَاء فَالْمُرَاد بِالْحَدِيثِ صُفُوف النِّسَاء اللَّوَاتِي يُصَلِّينَ مَعَ الرِّجَال، وَأَمَّا إِذَا صَلَّيْنَ مُتَمَيِّزَات لَا مَعَ الرِّجَال فَهُنَّ كَالرِّجَالِ خَيْر صُفُوفهنَّ أَوَّلهَا وَشَرّهَا آخِرهَا، وَالْمُرَاد بِشَرِّ الصُّفُوف فِي الرِّجَال النِّسَاء أَقَلّهَا ثَوَابًا وَفَضْلًا وَأَبْعَدهَا مِنْ مَطْلُوب الشَّرْع، وَخَيْرهَا بِعَكْسِهِ، وَإِنَّمَا فَضَّلَ آخِر صُفُوف النِّسَاء الْحَاضِرَات مَعَ الرِّجَال لِبُعْدِهِنَّ مِنْ مُخَالَطَة الرِّجَال وَرُؤْيَتهمْ وَتَعَلُّق الْقَلْب بِهِمْ عِنْد رُؤْيَة حَرَكَاتهمْ وَسَمَاع كَلَامهمْ وَنَحْو ذَلِكَ، وَذَمَّ أَوَّلَ صُفُوفهنَّ لِعَكْسِ ذَلِكَ . وَاَللَّه أَعْلَم .
وقال-رحمه الله-: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الصَّفَّ الأَْوَّل الْمَمْدُوحَ الَّذِي وَرَدَتِ الأَْحَادِيثُ بِفَضْلِهِ هُوَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِي الإِْمَامَ سَوَاءٌ تَخَلَّلَهُ مِنْبَرٌ أَوْ مَقْصُورَةٌ أَوْ أَعْمِدَةٌ أَوْ نَحْوُهَا، وَسَوَاءٌ جَاءَ صَاحِبُهُ مُقَدَّمًا أَوْ مُؤَخَّرًا هَذَا هُوَ الصَّحِيح الَّذِي يَقْتَضِيه ظَوَاهِر الْأَحَادِيث وَصَرَّحَ بِهِ الْمُحَقِّقُونَ. وَاَللَّه أَعْلَم. أنظر: شرح مسلم (2/183) بتصرف، و[الموسوعة الفقهية الكويتية 27/ 38].
(6) فَضْل مَيَامِنِ الصُّفُوفِ: عَنْ عَائِشَةَ-رضي الله عنها- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ e:« إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ » صحيح كما في "الفتح" (2/213) أنظر: القول المبين (صـ221) لمشهور. وعَنِ الْبَرَاءِ t قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ e أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ - قَالَ - فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ « رَبِّ قِنِى عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ »رواه مسلم ح (709). قال العلاَّمة ابن باز –رحمه الله-:(( قد ثبت عن النبي e ما يدل على أن يمين كل صفّ، أفضل من يساره، ولا يشرع أن يقال للناس : [اعدلوا الصف] ولا حرج أن يكون يمين الصف أكثر ، حرصاً على تحصيل الفضل .
أما ما ذكره بعضهم من حديث : ((مَنْ عمر مياسر الصفوف ، فله أجران)) فلا أعلم له أصلاً !! و الأظهر أنه موضوع ، وضعه بعض الكسالى الذين لا يحرصون على يمين الصف ، أو لا يسابقون إليه ، والله الهادي إلى سواء السبيل)) فتاوى ابن باز، 12/205.
(7) فَضْل وَصْل الصُّفُوُف والمشي إليها: رغَّب فيها النبي e، وحذّر من قطعها وَإِنْ وَجَدَ الْفُرْجَةَ فِي صَفٍّ مُتَقَدِّمٍ فَلَهُ أَنْ يَخْتَرِقَ الصُّفُوفَ لِيَصِل إِلَيْهَا لِتَقْصِيرِ الْمُصَلِّينَ فِي تَرْكِهَا، وَلأَِنَّ سَدَّ الْفُرْجَةِ الَّتِي فِي الصُّفُوفِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لَهُ وَلِلْقَوْمِ بِإِتْمَامِ صَلاَتِهِ وَصَلاَتِهِمْ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو t أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ e قَالَ :« مَنْ وَصَلَ صَفّاً وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفّاً قَطَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ » صحيح النسائي ح (819)، ولقوله e:«إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ، وَمَنْ سَدَّ فُرْجَهً رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَهً» صحيح ابن ماجه ح (995)، ولقوله e:« مَنْ سَدَّ فُرْجَه بَنَى اللهُ لَهُ بَيتاً فِي الْجَنَّة وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَة » الصحيحة ح (1892)، ولقوله e:« رَاصُّوا الصُّفُوفَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَقُومُ فِي الْخَلَلِ» صحيح الجامع ح (3454) . قال الإمام السيوطي-رحمه الله-: ((قالوا في الكلام على التَّخطيِّ : يُكره إلاَّ إذا كان بين يديه فرجة, لا يصل إليها إلاَّ بالتخطي (قلت: وإن كان في الصلاة), فإنَّهم مقصرون بتركها, إذ يكره إنشاء صفٍّ قبل إتمام ما قبله))[بسط الكف في إتمام الصف ص: 7].
(8) مسائل وأحكام:
الأولى: الْصَلَاةُ بَيّنَ الْسَّوَارِي: لا يخفى على المتأمل ما تحدثه الصلاة بين السواري من قطع للصفوف، وعدم التراصّ والالتصاق، فإنَّ في النهي عن الصلاة بين السواري دعوة واضحة إلى وحدة الصف، ولا يجوز لأحد أن يستهين بهذه الشعيرة، وبهذه السنة العظيمة الأثر، فالفقه السليم يمنع من ذلك، دون سماع نصٍ في المسألة، فكيف إذا كان؟ فالصف بين السواري يؤدي إلى قطع الصف وحينئذ يرد عليه قول رسول الله e: ((. . . وَمَنْ قَطَعَ صَفّاً قَطَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ))؛ وقد ورد فيها من النصوص الخاصة ما يفيد تحريم الصف بينها .
لهذا فقد تقرر عند المحققين من أهل العلم أنَّ صلاة المأمومين بين السواري تحرم إلاَّ للضرورة؛ للأدلة التالية :
أولاً: عَنْ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ الْمُزَنِىِّ t قَالَ:" كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ e وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا" الصحيحة ح (335).
ثانياً: عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ t قَالَ: " صَلَّيْنَا خَلْفَ أَمِيرٍ مِنَ الأُمَرَاءِ فَاضْطَرَّنَا النَّاسُ فَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ [فَجَعَلَ أَنَسٌ يَتَأَخَّرُ ] فَلَمَّا صَلَّيْنَا قَالَ: أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ t كُنَّا نَتَّقِى هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ e " أنظر: الصحيحة تحت ح (335).
قُلْتُ: نلاحظ في كلا الحديثين قولهما -رضي الله عنهما-: ((على عهد رسول الله e))؛ وتحتمل رواية أنس t إقرار الرسول e وهو في حكم المرفوع؛ أو أن في المسألة سنة قولية، وهو ما تأكده رواية قرَّة t فتحمل رواية أنس عليها؛ فقول قرَّة t : (كُنَّا نُنهى) يدل على ذلك، قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله- في (النزهة صـ138): " قول الصحابي: كنا نفعل كذا؛ فله حكم المرفوع"، وقال العلاَّمة ابن عثيمين-رحمه الله- في شرح رياض الصالحين (3/176): " لفظ: (نهينا)؛ إذا قاله صحابي أو صحابية؛ فالمعنى أن النبي e نهاهم، لأنَّ النبيe هو الذي له الأمر والنهي".
فإذا تقرر النهي عنه e؛ فالأصل فيه أنَّه للتحريم إلاَّ إذا دلَّ الدليلُ على الكراهة؛ ولا صارف ولفظ "نُطرَد" يُشعر بالتحريم، ثم إيراد المفعول المطلق "طرداً" مما يزيده تأكيداً.
قال الإمام الشوكاني -رحمه الله-: " وَظَاهِر حَدِيث مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ وَحَدِيث أَنَسٍ الَّذِي ذَكَره الْحَاكِم أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّم"نيل الأوطار 3/236.
قال العلاَّمة الألباني -رحمه الله- عن الصفِّ بين السواري من غير ضرورة للجماعة: "حرامٌ لا يجوز"بداية الشريط الرابع من سلسلة الهدى والنور، وقال-رحمه الله- عن حديث أنس:" هذا الحديث نص صريح في ترك الصف بين السواري، وأنَّ الواجب أن يتقدم أو يتأخر، إلاَّ عند الاضطرار؛ كما وقع لهم"الصحيحةح360، ويعود الضمير: (لهم) على الصحابة كما في رواية الترمذي التي سبق ذكرها. وأجاب العلاَّمة ابن عثيمين -رحمه الله- عندما سُئل عما ورد من أن الصحابة y كانوا يطردون عن الصف بين السواري طرداً، وكانوا يتقون الصف فيها، فهل الصف بينها محرم كما هو ظاهر النهي؟ فقال: " الصحيح: أنه منهي عنه؛ لأنه يؤدي إلى انقطاع الصف لاسيما مع عرض السارية"مجموع الفتاوى الفتوى 360 .
قُلْتُ: والواضح مما سلف ذكره أن الأمر يتعلق بالجماعة في حالة السعة أما في حالة الإنفراد بالصلاة والضيق بالجماعة، فقال الحافظ ابن حجر-رحمه الله-: قَوْله – أي الإمام البخاري- : ( بَاب الصَّلَاة بَيْنَ السَّوَارِي فِي غَيْرِ جَمَاعَةِ ) إِنَّمَا قَيَّدَهَا بِغَيْرِ الْجَمَاعَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَقْطَعُ الصُّفُوف ، وَتَسْوِيَة الصُّفُوف فِي الْجَمَاعَةِ مَطْلُوب .
وَقَالَ الرَّافِعِيّ فِي شَرْح الْمُسْنَد : اِحْتَجَّ الْبُخَارِيّ بِهَذَا الْحَدِيثِ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ t قَالَ: دَخَلَ النَّبِىُّ e الْبَيْتَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَبِلاَلٌ y، فَأَطَالَ ثُمَّ خَرَجَ ، وَكُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ دَخَلَ عَلَى أَثَرِهِ فَسَأَلْتُ بِلاَلاً أَيْنَ صَلَّى ؟ قَالَ: " بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ" متفق عليه. عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي جَمَاعَة، وَأَشَارَ أَنَّ الْأَوْلَى لِلْمُنْفَرِدِ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى السَّارِيَةِ قُلْتُ: بل هو مستحب لحديث أَنَسٍ t قَالَ: " لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِىِّ e يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِىَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ "رواه البخاري ح (503). قَالَ الْمُحِبّ الطَّبَرِيُّ: كَرِهَ قَوْم الصَّفّ بَيْنَ السَّوَارِي لِلنَّهْي الْوَارِدِ عَنْ ذَلِكَ ، وَمَحَلّ الْكَرَاهَة عِنْدَ عَدَمِ الضِّيقِ ، الْحِكْمَة فِيهِ إِمَّا لِانْقِطَاع الصَّفّ أَوْ ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ النِّعَالِ . اِنْتَهَى . وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ : رُوِيَ فِي سَبَبِ كَرَاهَةِ ذَلِكَ أَنَّهُ مُصَلَّى الْجِنّ الْمُؤْمِنِينَ . " فتح الباري " (1/578) بتصرف.
الثانية: صَلاَةُ الرَّجُل وَحْدَهُ خَلْفَ الصُّفُوفِ : الأَْصْل فِي صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُومُونَ صُفُوفًا مُتَرَاصَّةً كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ - وَلِذَلِكَ يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَاحِدٌ مُنْفَرِدًا خَلْفَ الصُّفُوفِ دُونَ عُذْرٍ، وَصَلاَتُهُ صَحِيحَةٌ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَتَنْتَفِي الْكَرَاهَةُ بِوُجُودِ الْعُذْرِ عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ .
وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ : - الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ - وَالأَْصْل فِيهِ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ t: أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ e وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْل أَنْ يَصِل إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ e فَقَال: « زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ » ح(783).
قَال الْفُقَهَاءُ : يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ عَدَمُ لُزُومِ الإِْعَادَةِ، وَأَنَّ الأَْمْرَ الَّذِي وَرَدَ فِي حَدِيثِ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الَّذِي رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ e :"رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاَةَ "صحيح سنن أبي داود ح(682). هَذَا الأَْمْرُ بِالإِْعَادَةِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى سَبِيل الاِسْتِحْبَابِ؛ جَمْعًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ .[الموسوعة الفقهية 27/ 184].
قال العلاَّمة الألباني-رحمه الله- في " الضعيفة" (2/421) :" لا يصحُّ حينئذ القول بمشروعية جذب الرَّجل من الصف ليصف معه، لأنَّه تشريع بدون نصٍّ صحيح، وهذا لا يجوز، بل الواجب أن ينضم إلى الصّف إذا أمكن وإلاَّ صلى وحده، وصلاته صحيحة، لأنَّه {لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا}[البقرة/233]، وحديث الأمر بالإعادة محمول على ما إذا قصَّر في الواجب وهو الانضمام في الصف وسدّ الفرج, وأمّا إذا لم يجد فرجة، فليس بمقصِّر، فلا يعقل أن يحكم على صلاته بالبطلان في هذه الحالة، و هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-، فقال في الاختيارات "(ص 42):" وتصحّ صلاة الفذّ لعذر، وقاله الحنفية، وإذا لم يجد إلاَّ موقفا خلف الصَّف، فالأفضل أن يقف وحده ولا يجذب من يُصافه ، لما في الجذب من التصرُّف في المجذوب، فإن كان المجذوب يطيعه، فأيُّهما أفضل له وللمجذوب ؟ الاصطفاف مع بقاء فرجة ، أو وقوف المتأخِّر وحده ؟ وكذلك لو حضر اثنان، وفي الصَّف فرجة، فأيُّهما أفضل وقوفهما جميعا أوسدُّ أحدهما الفرجة، وينفرد الآخر ؟ الرَّاجح الاصطفاف مع بقاء الفرجة، لأنَّ سدُّ الفرجة مستحب، والاصطفاف واجب " . قلت : كيف يكون سدُّ الفرج مستحبًا فقط، ورسول الله e يقول في الحديث الصحيح : " مَنْ وَصَلَ صَفّاً وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفّاً قَطَعَهُ اللهُ " فالحقُّ أنَّ سدَّ الفرج واجب ما أمكن، وإلاَّ وقف وحده لما سبق . و الله أعلم .
وَفِيمَا يَلِي بَيَانُ كَيْفِيَّةِ تَصَرُّفِ الْمَأْمُومِ لِيَجْتَنِبَ الصَّلاَةَ مُنْفَرِدًا خَلْفَ الصَّفِّ، حَتَّى تَنْتَفِيَ الْكَرَاهَةُ، كَمَا يَقُول جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ :
(1) مَنْ دَخَل الْمَسْجِدَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الْجَمَاعَةُ، فَإِنْ وَجَدَ فُرْجَةً فِي الصَّفِّ الأَْخِيرِ وَقَفَ فِيهَا، أَوْ وَجَدَ الصَّفَّ غَيْرَ مَرْصُوصٍ وَقَفَ فِيهِ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ e: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ" صحيح ابن ماجه ح (995).
(2) وَإِنْ وَجَدَ الْفُرْجَةَ فِي صَفٍّ مُتَقَدِّمٍ فَلَهُ أَنْ يَخْتَرِقَ الصُّفُوفَ لِيَصِل إِلَيْهَا لِتَقْصِيرِ الْمُصَلِّينَ فِي تَرْكِهَا، وَلأَِنَّ سَدَّ الْفُرْجَةِ الَّتِي فِي الصُّفُوفِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لَهُ وَلِلْقَوْمِ بِإِتْمَامِ صَلاَتِهِ وَصَلاَتِهِمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ. (متفق عليه)، وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ e بِسَدِّ الْفُرَجِ. صحيح الجامع (1187).
الثالثة: اتصال الصفوف: اتصال الصفوف سنة، للجماعة داخل المسجد، أما إذا كانوا خارج المسجد فإن الصلاة لا تصح لمن كان خارج المسجد إذا لم تتصل الصفوف، فاشتراط اتصال الصفوف لصحة الصلاة إنما يكون إذا كان المصلي خارج المسجد.
أما إذا كان داخل المسجد فإنه يصح أن يصلي في آخر المسجد ولو لم يكن بينه وبين الصف الأول في المسجد أحد؛ ولكن هذا خلاف السنة؛ لأن السنة التقارب بين الصفوف.
قال العلاَّمة ابن عثيمين-رحمه الله-: والذي مشى عليه صاحبُ «المقنع»: أنَّه لا بُدَّ مِن اتِّصالِ الصُّفوفِ، وأنَّه لا يَصِحُّ إقتداءُ مَن كان خارجَ المسجدِ إلا إذا كانت الصُّفوفُ متَّصلةً؛ لأنَّ الواجبَ في الجماعةِ أن تكون مجتمعةً في الأفعالِ وهي متابعة المأمومِ للإِمام _ والمكان. وإلا لقلنا: يَصِحُّ أن يكون إمامٌ ومأمومٌ واحد في المسجد، ومأمومان في حجرة بينها وبين المسجد مسافة، ومأمومان آخران في حجرة بينه وبين المسجدِ مسافة، ومأمومان آخران بينهما وبين المسجد مسافة في حجرة ثالثة، ولا شَكَّ أنَّ هذا توزيعٌ للجماعةِ، ولاسيَّما على قولِ مَن يقول: إنَّه يجب أن تُصلَّى الجماعةُ في المساجد.
فالصَّوابُ في هذه المسألة: أنَّه لا بُدَّ في إقتداء مَن كان خارجَ المسجدِ مِن اتِّصالِ الصُّفوفِ، فإنْ لم تكن متَّصِلة فإنَّ الصَّلاة لا تَصِحُّ.
مثال ذلك: يوجد حولَ الحَرَمِ عَماراتٌ، فيها شُقق يُصلِّي فيها الناسُ، وهم يَرَون الإِمامَ أو المأمومين، إما في الصَّلاةِ كلِّها؛ أو في بعضِها، فعلى كلامِ المؤلِّفِ تكون الصَّلاةُ صحيحةً، ونقول لهم: إذا سمعتم الإِقامة فلكم أنْ تبقوا في مكانِكم وتصلُّوا مع الإِمام ولا تأتوا إلى المسجدِ الحرام.
وعلى القول الثاني: لا تَصِحُّ الصَّلاةُ؛ لأنَّ الصفوفَ غيرُ متَّصلةٍ. وهذا القولُ هو الصَّحيحُ، وبه يندفع ما أفتى به بعضُ المعاصرين مِن أنَّه يجوز الإقتداءُ بالإِمامِ خلفَ «المِذياعِ»، ويلزمُ على هذا القول أن لا نصلِّيَ الجمعةَ في الجوامع بل نقتدي بإمام المسجدِ الحرامِ؛ لأنَّ الجماعةَ فيه أكثرُ فيكون أفضلَ، مع أنَّ الذي يصلِّي خلفَ «المِذياع» لا يرى فيه المأموم ولا الإِمامَ، فإذا جاء «التلفاز» الذي ينقل الصَّلاة مباشرة يكون مِن بابِ أَولى، وعلى هذا القول اجعلْ «التلفزيون» أمامَك وصَلِّ خلفَ إمامِ الحَرَمِ، واحْمَدِ اللهَ على هذه النِّعمةِ؛ لأنَّه يشاركك في هذه الصَّلاةِ آلاف النَّاس، وصلاتك في مسجدك قد لا يبلغون الألف.
ولكن؛ هذا القولُ لا شَكَّ أنَّه قولٌ باطلٌ؛ لأنه يؤدِّي إلى إبطالِ صلاةِ الجماعةِ أو الجُمعة، وليس فيه اتِّصالَ الصُّفوفِ، وهو بعيدٌ مِن مقصودِ الشَّارعِ بصلاةِ الجمعةِ والجماعةِ.
فالرَّاجح: أنه لا يَصِحُّ إقتداءُ المأمومِ خارجَ المسجد إلا إذا اتَّصلتِ الصُّفوف، فلا بُدَّ له مِن شرطين:
1 _ أن يَسمعَ التكبيرَ. 2 _ اتِّصال الصُّفوف.
أما اشتراطُ الرُّؤيةِ ففيه نظر، فما دام يَسمعُ التَّكبير والصُّفوف متَّصلة فالإقتداء صحيح، وعلى هذا؛ إذا امتلأ المسجدُ واتَّصلتِ الصُّفوف وصَلَّى النَّاسُ بالأسواقِ وعلى عتبة الدَّكاكين فلا بأس به. الشرح الممتع (4/297ـ300) بتصرف.
وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ-رَحِمَهُ اللَّهُ- عَنْ الْحَوَانِيتِ الْمُجَاوِرَةِ لِلْجَامِعِ مِنْ أَرْبَابِ الْأَسْوَاقِ . إذَا اتَّصَلَتْ بِهِمْ الصُّفُوفُ . فَهَلْ تَجُوزُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فِي حَوَانِيتِهِمْ ؟ .
فَأَجَابَ : أَمَّا صَلَاةُ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَعَلَى النَّاسِ أَنْ يَسُدُّوا الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ. فَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَسُدَّ الصُّفُوفَ الْمُؤَخَّرَةَ مَعَ خُلُوِّ الْمُقَدِّمَةِ وَلَا يُصَفُّ فِي الطُّرُقَاتِ وَالْحَوَانِيتِ مَعَ خُلُوِّ الْمَسْجِدِ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ التَّأْدِيبَ وَلِمَنْ جَاءَ بَعْدَهُ تَخَطِّيهِ وَيَدْخُلُ لِتَكْمِيلِ الصُّفُوفِ الْمُقَدَّمَةِ فَإِنَّ هَذَا لَا حُرْمَةَ لَهُ .
فإذَا امْتَلَأَ الْمَسْجِدُ بِالصُّفُوفِ صَفُّوا خَارِجَ الْمَسْجِدِ فَإِذَا اتَّصَلَتْ الصُّفُوفُ حِينَئِذٍ فِي الطُّرُقَاتِ وَالْأَسْوَاقِ صَحَّتْ صَلَاتُهُمْ . وَأَمَّا إذَا صَفُّوا وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الصَّفِّ الْآخَرِ طَرِيقٌ يَمْشِي النَّاسُ فِيهِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُمْ فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ . وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الصُّفُوفِ حَائِطٌ بِحَيْثُ لَا يَرَوْنَ الصُّفُوفَ وَلَكِنْ يَسْمَعُونَ التَّكْبِيرَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَإِنَّهُ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُمْ فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ . وَكَذَلِكَ مَنْ صَلَّى فِي حَانُوتِهِ وَالطَّرِيقُ خَالٍ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْعُدَ فِي الْحَانُوتِ وَيَنْتَظِرَ اتِّصَالَ الصُّفُوفِ بِهِ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَذْهَبَ إلَى الْمَسْجِدِ فَيَسُدَّ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . مجموع الفتاوى (23/410) بتصرف.
وَقَالَ الإمام ابن قدامة-رَحِمَهُ اللَّهُ-: ( وَيَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ مَنْ فِي أَعْلَى الْمَسْجِدِ وَغَيْرِ الْمَسْجِدِ، إذَا اتَّصَلَتْ الصُّفُوفُ ) وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . المغني (3/448).
الرابعة: وضع خطوط في المسجد لتسوية الصفوف: الأمر بتسوية الصفوف وارد في أحاديث كثيرة مشهورة ذكرنها آنفاً، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى القول بوجوب تسوية الصفوف؛ " لأن النبي e لما رَأَى رَجُلاً بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ قَالَ: « عِبَادَ اللَّهِ، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ »متفق عليه، وهذا وعيد ، ولا وعيد إلا على فعل محرم أو ترك واجب. والقول بوجوب تسوية الصفوف قول قوي" أنظر:فتاوى العثيمين (ج13 سؤال رقم 375)، وينبغي للإمام أن يأمر الناس بالتسوية، وأن يتعاهدهم في ذلك .وأما وضع خط على الحصير أو السجاد للمساعدة في تسوية الصف، فلا حرج فيه، وليس هو من البدع . وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم عمل خط على الحصير أو السجاد بالمسجد نظرا إلى أن القبلة منحرفة قليلا بقصد انتظام الصف ؟
فأجابت :"لا بأس بذلك، وإن صلوا في مثل ذلك بلا خط فلا بأس؛ لأن الميل اليسير لا أثر له" أنظر:
"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/315)، وسئل العلاَّمة عبد الرزاق عفيفي-رحمه الله-: عن حكم رسم خطوط المساجد لتستوي الصفوف عليها . فأجاب : "إذا كان الناس لا تستقيم صفوفهم إلا بذلك فلا بأس، أو كان المسجد قد بني منحرفا عن القبلة ولا تستقيم الصفوف فيه إلا برسم خطوط فلا بأس بذلك إن شاء الله "أنظر: "فتاوى ورسائل عبد الرزاق عفيفي" ص 412 .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/315)، وسئل العلاَّمة عبد الرزاق عفيفي-رحمه الله-: عن حكم رسم خطوط المساجد لتستوي الصفوف عليها . فأجاب : "إذا كان الناس لا تستقيم صفوفهم إلا بذلك فلا بأس، أو كان المسجد قد بني منحرفا عن القبلة ولا تستقيم الصفوف فيه إلا برسم خطوط فلا بأس بذلك إن شاء الله "أنظر: "فتاوى ورسائل عبد الرزاق عفيفي" ص 412 .
وقال العلاَّمة ابن عثيمين-رحمه الله-: " البدعة هي التعبد لله عز وجل بغير ما شرع . وعلى هذا فالبدع لا تدخل في غير العبادات ، بل ما أُحدث من أمور الدنيا ينظر فيه هل هو حلال أم حرام ، ولا يقال إنه بدعة . فالبدعة الشرعية هي أن يتعبد الإنسان لله تعالى بغير ما شرع يعني الذي يسمى بدعة شرعاً ، وأما البدعة في الدنيا فإنها وإن سميت بدعةً حسب اللغة العربية فإنها ليست بدعةً دينية بمعنى أنه لا يحكم عليها بالتحريم ولا بالتحليل ولا بالوجوب ولا بالاستحباب إلا إذا اقتضت الأدلة الشرعية ذلك . وعلى هذا فما أحدثه الناس اليوم من الأشياء المقربة إلى تحقيق العبادة لا نقول إنها بدعة وإن كانت ليست موجودة، من ذلك مكبّر الصوت . مكبر الصوت ليس موجوداً في عهد النبي e لكنه حدث أخيراً إلا أن فيه مصلحة دينية يبلغ للناس صلاة الإمام وقراءة الإمام والخطبة، وكذلك في اجتماعات المحاضرات فهو من هذه الناحية خير ومصلحة للعباد، فيكون خيراً، ويكون شراؤه للمسجد لهذا الغرض من الأمور المشروعة التي يثاب عليها فاعلها .
ومن ذلك ما حدث أخيراً في مساجدنا من الفرش التي فيها خطوط من أجل إقامة الصفوف وتسويتها فإن هذا وإن كان حادثاً ولكنه وسيلةٌ لأمرٍ مشروع ، فيكون جائزاً أو مشروعاً لغيره، ولا يخفى على الناس ما كان الأئمة الحريصون على تسوية الصفوف يعانونه قبل هذه الخطوط ، فكانوا يعانون مشاكل إذا تقدم أحد ثم قالوا له تأخر. تأخرَ أكثر ثم قالوا له تقدم. تقدم أكثر يحصل تعب . الآن والحمد لله يقول الإمام : سووا صفوفكم على الخطوط، توسطوا منها، فيحصل انضباطٌ تام في إقامة الصف . هذا بدعة من حيث العمل والإيجاد، لكنه ليس بدعة من حيث الشرع؛ لأنه وسيلة لأمرٍ مطلوبٍ شرعاً " أنظر: "فتاوى نور على الدرب- علوم القرآن وتفسيره" .
ومن ذلك ما حدث أخيراً في مساجدنا من الفرش التي فيها خطوط من أجل إقامة الصفوف وتسويتها فإن هذا وإن كان حادثاً ولكنه وسيلةٌ لأمرٍ مشروع ، فيكون جائزاً أو مشروعاً لغيره، ولا يخفى على الناس ما كان الأئمة الحريصون على تسوية الصفوف يعانونه قبل هذه الخطوط ، فكانوا يعانون مشاكل إذا تقدم أحد ثم قالوا له تأخر. تأخرَ أكثر ثم قالوا له تقدم. تقدم أكثر يحصل تعب . الآن والحمد لله يقول الإمام : سووا صفوفكم على الخطوط، توسطوا منها، فيحصل انضباطٌ تام في إقامة الصف . هذا بدعة من حيث العمل والإيجاد، لكنه ليس بدعة من حيث الشرع؛ لأنه وسيلة لأمرٍ مطلوبٍ شرعاً " أنظر: "فتاوى نور على الدرب- علوم القرآن وتفسيره" .
الخامسة: الصَّفُّ فِي صَلاَةِ الْجِنَازَةِ : قَال الْفُقَهَاءُ : يُسْتَحَبُّ تَسْوِيَةُ الصَّفِّ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ e نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا.متفق عليه، وَوَرَدَ أَنَّ أَبَا بَكَّارٍ الْحَكَمَ بْنَ فَرُّوخَ-رحمه الله- قَال : صَلَّى بِنَا أَبُو الْمَلِيحِ عَلَى جِنَازَةٍ فَظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ كَبَّرَ فَأَقْبَل عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَال : أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَلْتَحْسُنْ شَفَاعَتُكُمْ. صحيح الجامع ح( 5787 ).أنظر: [الموسوعة الفقهية 27/ 40]بتصرف.
وسئل العلاَّمة ابن عثيمين-رحمه الله-: عن حكم تسوية الصفوف في صلاة الجنازة؟
فأجاب: عموم الأدلة تدل على تسوية الصفوف في كل جماعة، في الفريضة، أو النافلة كصلاة القيام، أو الجنازة، أو جماعة النساء. فمتى شرع الصف شرعت فيه المساواة. أنظر:فتاوى العثيمين (ج13 سؤال رقم 376)
السادسة: الصلاة على الكرسي: قال شيخ الإسلام –رحمه الله- : " اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إذَا عَجَزَ عَنْ بَعْضِ وَاجِبَاتِهَا كَالْقِيَامِ أَوْ الْقِرَاءَةِ أَوْ الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ أَوْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ أَوْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ سَقَطَ عَنْهُ مَا عَجَزَ عَنْهُ " مجموع الفتاوى (8/437)، وبناءً على ذلك : فإن من صلى الفريضة جالساً وهو قادر على القيام فصلاته باطلة .
ومما ينبغي التنبه له : أنه إذا كان معذوراً في ترك القيام فلا يبيح له عذره هذا الجلوس على الكرسي لركوعه وسجوده .
وإذا كان معذوراً في ترك الركوع والسجود على هيئتهما فلا يبيح له عذره هذا عدم القيام والجلوس على الكرسي .
فالقاعدة في واجبات الصلاة : أن ما استطاع المصلي فعله، وجب عليه فعله، وما عجز عن فعله سقط عنه .
فمن كان عاجزاً عن القيام جاز له الجلوس على الكرسي أثناء القيام، ويأتي بالركوع والسجود على هيئتهما، فإن استطاع القيام وشقَّ عليه الركوع والسجود: فيصلي قائماً ثم يجلس على الكرسي عند الركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه .
قال الإمام ابن قدامة-رحمه الله- : "وَمَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ ، وَعَجَزَ عَنْ الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ ، لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْقِيَامُ ، وَيُصَلِّي قَائِمًا ، فَيُومِئُ بِالرُّكُوعِ ، ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُومِئُ بِالسُّجُودِ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ... لقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ }، وَقَوْلِ النَّبِيِّ e: { صَلِّ قَائِمًا }، وَلِأَنَّ الْقِيَامَ رُكْنٌ قَدَرَ عَلَيْهِ، فَلَزِمَهُ الْإِتْيَانُ بِهِ، كَالْقِرَاءَةِ، وَالْعَجْزُ عَنْ غَيْرِهِ لَا يَقْتَضِي سُقُوطَهُ، كَمَا لَوْ عَجَزَ عَنْ الْقِرَاءَةِ. "المغني" (1/444)بتصرف.
قُلْتُ: وأما وضع الكرسي في الصف فقد ذكر العلماء-رحمهم الله- أن العبرة فيمن صلى جالساً مساواة الصف بمقعدته، فلا يتقدم أو يتأخر عن الصف بها، لأنها الموضع الذي يستقر عليه البدن .انظر : "أسنى المطالب" (1/222) ، "تحفة المحتاج" (2/157) ، "شرح منتهى الإرادات" (1/279) .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (6/21) : وَالاعْتِبَارُ فِي التَّقَدُّمِ وَعَدَمِهِ لِلْقَائِمِ بِالْعَقِبِ , وَهُوَ مُؤْخِرُ الْقَدَمِ لا الْكَعْبِ , فَلَوْ تَسَاوَيَا فِي الْعَقِبِ وَتَقَدَّمَتْ أَصَابِعُ الْمَأْمُومِ لِطُولِ قَدَمِهِ لَمْ يَضُرَّ . . . . . وَالْعِبْرَةُ فِي التَّقَدُّمِ بِالأَلْيَةِ لِلْقَاعِدِينَ, وَبِالْجَنْبِ لِلْمُضْطَجِعِينَ "، فإن كان المصلي سيجلس على الكرسي من أول الصلاة إلى آخرها فإنه يحاذي الصف بموضع جلوسه، أما إن كان يقوم في القيام، و لكنه يجلس على الكرسي عند الركوع والسجود، فهذا يجعل أقدامه محاذية للصف عند القيام. أنظر:[الخلاصة في فقه الأقليات 4/ 31].
هذا والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
الانتهاء في
ليلة 22/ من ربيع الآخر / 1432هـ
الموافق 27/ من مارس / 2011م